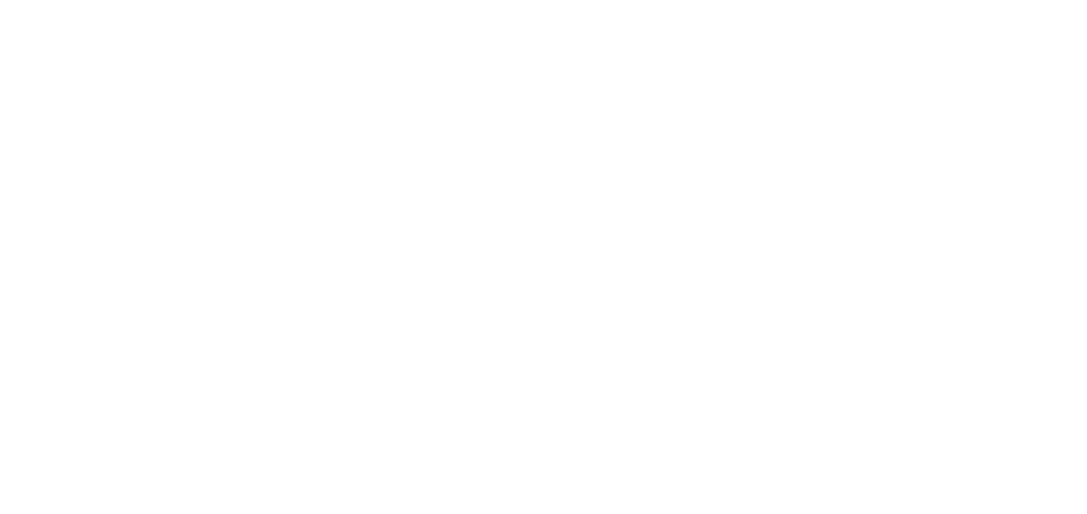العنف الأسري وثقافة الموروث الاجتماعي
تُعد قضية العنف الأسري من القضايا الاجتماعية والإنسانية المعقدة، التي تستدعي قراءة معمقة لجذورها وأسبابها، بعيدًا عن المعالجات السطحية التي تكتفي بوصف الظاهرة دون الغوص في بنيتها الثقافية والسوسيولوجية. إن العنف الأسري ليس مجرد سلوك منحرف أو خروج عن القاعدة الأخلاقية، بل هو انعكاس مباشر لبنية ثقافية متجذرة، تعبّر عنها الموروثات الاجتماعية والتقاليد البالية التي تشكل الوعي الجمعي وتحدد العلاقات داخل الأسرة والمجتمع. فحين يكون العنف مقبولًا بصيغة ما داخل النسيج الثقافي، يتحول من كونه استثناءً إلى كونه نمطًا شبه طبيعي، يمارس في الخفاء أو العلن، ويُبرر بعبارات شرعية أو عرفية.
مفهوم العنف الأسري
العنف الأسري هو استخدام أحد أفراد الأسرة -عادة من يمتلك سلطة أو نفوذًا أكبر كالزوج أو الأب أو الأخ الأكبر- للقوة أو السيطرة أو الإكراه ضد فرد آخر من الأسرة، بهدف إخضاعه أو التحكم في سلوكه أو إرغامه على التصرف وفق نمط محدد. ويأخذ هذا العنف أشكالًا متعددة، منها الجسدي، والنفسي، واللفظي، والجنسي، والاقتصادي، وقد يُمارس بشكل مباشر أو عبر أساليب القهر النفسي المستترة.
ويمتاز العنف الأسري بخطورته المزدوجة: فهو أولًا يُمارَس في إطار العلاقة الأقرب للإنسان -الأسرة- وهي المفترض أن تكون مصدر أمان وطمأنينة، وثانيًا لأنه غالبًا ما يُمارس في الخفاء، بعيدًا عن أعين القانون والمجتمع، ما يجعل ضحاياه في عزلة مضاعفة، بين الألم والسكوت.
الجذور الثقافية والاجتماعية للعنف الأسري
ليست كل مظاهر العنف الأسري نابعة من الانفعال الفردي أو الظروف الآنية. كثير منها متجذر في البنية الثقافية والتربوية التي تكرّس السلطة الأبوية، وتمنح الذكر سلطات شبه مطلقة داخل الأسرة، وتختزل دور المرأة أو الطفل في الطاعة والانصياع. وهنا تبرز خطورة الموروث الثقافي، حين يتحول إلى مرجعية تبرر الظلم، وتكرّس الخضوع، وتعيق أي تحول اجتماعي نحو العدالة والمساواة.
الهيمنة الذكورية
تعزز العديد من المجتمعات العربية ثقافة الهيمنة الذكورية، التي تجعل الرجل مركز السلطة داخل الأسرة، وتُحمّله دور القائد والحامي، لكنه في كثير من الأحيان يُمارس هذا الدور عبر القمع والتسلط بدلًا من الحوار والاحتواء. وهذه الهيمنة ليست فقط قانونية أو اقتصادية، بل أيضًا رمزية، إذ تنبع من المرويات الشفهية، والأمثال الشعبية، والمناهج الدراسية، والتنشئة الاجتماعية، التي تُعيد إنتاج صورة “الرجل القوي” الذي لا يُعارَض، و”المرأة الصبورة” التي تحتمل الأذى.
التنشئة الاجتماعية القمعية
يتعلم الأطفال منذ الصغر أن الصراخ والضرب قد يكونان وسيلتين لحل النزاعات داخل البيت، ويرون في العقاب الجسدي تعبيرًا مشروعًا عن التربية، وهو ما يجعلهم إما ضحايا للعنف أو ممارسين له في المستقبل. فالثقافة التي لا تعلّم الطفل كيف يعبر عن مشاعره، أو كيف يختلف مع الآخر دون أن يُقصى أو يُعاقب، هي ثقافة تصنع عنفًا يُعاد إنتاجه عبر الأجيال.
شرعنة العنف عبر الموروث الديني والثقافي
من أخطر مظاهر العنف الأسري أنه يجد في بعض التفاسير الدينية أو التأويلات الثقافية ما يبرّره، بل ويجعله يبدو في صورة “تأديب” أو “قوامة” أو “حماية للمرأة”. وهذه المبررات تتسلل إلى الوعي الجمعي عبر الخطب والبرامج والقصص التي تُنتجها المجتمعات، فتجعل من العنف سلوكًا مألوفًا لا يثير الاشمئزاز ولا يستدعي التدخل.
الأثر النفسي والاجتماعي للعنف الأسري
إن العنف الأسري لا يُنتج أذى لحظيًا فحسب، بل يترك آثارًا عميقة في نفسية الضحية، ويشوّه بنيانها الداخلي. فالفرد المعنّف -سواء كان امرأة أو طفلًا- يفقد ثقته بنفسه، وينمو داخل بيئة من الخوف والاضطراب، ما يُفضي إلى مشكلات نفسية مزمنة كالاكتئاب، واضطرابات القلق، واضطراب ما بعد الصدمة.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن العنف الأسري يُنتج جيلًا معطوبًا في علاقته بالعالم، يفتقد للثقة بالآخر، ويعيد إنتاج العنف في محيطه، سواء عبر تقليد السلوك الذي تعرض له أو عبر السعي للتفريغ النفسي عبر وسائل عنيفة. كما يؤدي هذا العنف إلى تفكك النسيج الأسري، وزيادة نسب الطلاق، وانحراف الأبناء، وتفشي السلوكيات المنحرفة في المجتمع.
العنف الأسري في ظل الصمت المجتمعي
الصمت المجتمعي حيال العنف الأسري يُعد مشاركة غير مباشرة في تكريسه. كثير من النساء يرفضن الإفصاح عن معاناتهن خوفًا من الفضيحة أو لحماية الأبناء أو بسبب الجهل بالحقوق القانونية. أما الأطفال، فهم غالبًا ما يُسكتون تحت وطأة التهديد، أو لأنهم لا يملكون أصواتًا مسموعة في المجتمع.
وغالبًا ما يتم تحميل الضحية مسؤولية العنف الواقع عليها، إذ يُقال للمرأة: “لو أطعتِه ما ضربك”، أو يُلام الطفل: “لماذا لم تذاكر؟”، ما يُضعف فرص التغيير، ويحول دون قيام حركة واعية لمناهضة العنف الأسري.
العنف الأسري في ضوء التحولات الاجتماعية
مع تسارع وتيرة التحديث الاجتماعي والتعليمي، باتت هناك محاولات جادة لإعادة النظر في ممارسات العنف الأسري، وخاصة في ظل توسع التعليم، وازدياد وعي النساء بحقوقهن، ودخولهن في سوق العمل، بالإضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في فضح الممارسات العنيفة. ورغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بسبب استمرار المرجعيات الثقافية التقليدية، وضعف البنية القانونية والمؤسساتية التي تُعنى بحماية الأسرة.
دور القانون في مناهضة العنف الأسري
تلعب التشريعات القانونية دورًا جوهريًا في التصدي للعنف الأسري، لكن فعالية هذه القوانين تعتمد على مدى جدية تطبيقها، وعلى حجم الوعي المجتمعي بها. بعض الدول العربية أقرت قوانين تجرّم العنف الأسري، وأنشأت مراكز لحماية الضحايا، إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تصطدم بعوائق التنفيذ، مثل النظرة القبلية التي ترفض تدخل الدولة في “شؤون العائلة”، أو ضعف آليات الإبلاغ والحماية، أو خوف الضحايا من فقدان حضانة أطفالهن.
الجدول: مقارنة بين أسباب العنف الأسري وآثاره على الضحية
| العنصر | الأسباب | الآثار على الضحية |
|---|---|---|
| الهيمنة الذكورية | ترسيخ سلطة الرجل كقائد مطلق للأسرة | فقدان الاستقلالية، اضطرابات نفسية |
| التنشئة الاجتماعية | قبول العقاب الجسدي كوسيلة للتربية | الخوف الدائم، ضعف الشخصية |
| الموروث الثقافي والديني | تأويلات خاطئة تشرعن القمع | قبول العنف كقدر، فقدان الثقة بالنفس |
| الصمت المجتمعي | العيب، الخوف من الفضيحة، جهل بالحقوق | العزلة، استمرار المعاناة، انتقال العنف للأبناء |
| غياب الردع القانوني | قوانين ضعيفة أو غير مفعّلة | استمرار العنف، انعدام الحماية القانونية |
دور التعليم والإعلام في تغيير الثقافة المجتمعية
لا يمكن مواجهة العنف الأسري دون تدخل تربوي وإعلامي فاعل يشتغل على تفكيك الصور النمطية التي تبرر القمع والتسلط داخل الأسرة. فالتعليم القائم على المساواة والاحترام والتعددية، قادر على تربية جيل يرفض العنف بوصفه أسلوبًا لحل النزاعات. كما أن الإعلام المستنير يمكنه أن يفتح النقاش حول المسكوت عنه، ويسلط الضوء على قصص الضحايا، ويُظهر بشاعة العنف ونتائجه المدمرة.
ينبغي أن تساهم المناهج الدراسية في ترسيخ ثقافة اللاعنف منذ المراحل الأولى، من خلال سرديات بديلة تُعيد الاعتبار للحوار، وللعلاقات المتوازنة، ولحقوق الإنسان داخل الأسرة. كما أن التدريب المستمر للمعلمين على اكتشاف ضحايا العنف الأسري بين طلابهم يشكل مدخلًا وقائيًا مهمًا.
نحو بنية أسرية عادلة ومتوازنة
بناء أسرة متماسكة وعادلة يتطلب مراجعة شاملة للقيم الثقافية التي ترسم ملامح العلاقات داخل البيت، ومحاسبة الموروثات التي تُعلي من شأن السيطرة والبطش على حساب الرحمة والمودة. كما أن التحول نحو العدالة الأسرية لا يعني نزع سلطة أحد على حساب الآخر، بل إعادة توزيع الأدوار بما يضمن الاحترام المتبادل، والشراكة في اتخاذ القرار، والمسؤولية المشتركة عن الحياة الزوجية وتربية الأبناء.
لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية حقيقية في ظل بيوت تنهشها أنياب العنف، وأفراد يتألمون في صمت. إن تطهير الثقافة من شرعية العنف هو المدخل الحقيقي لأي تحول حضاري، يبدأ من البيت، ويمتد ليشمل الدولة والمجتمع.
المراجع:
-
Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence against women, 4(3), 262-290.
-
Krug, E. G., et al. (2002). World report on violence and health. Geneva: World Health Organization.