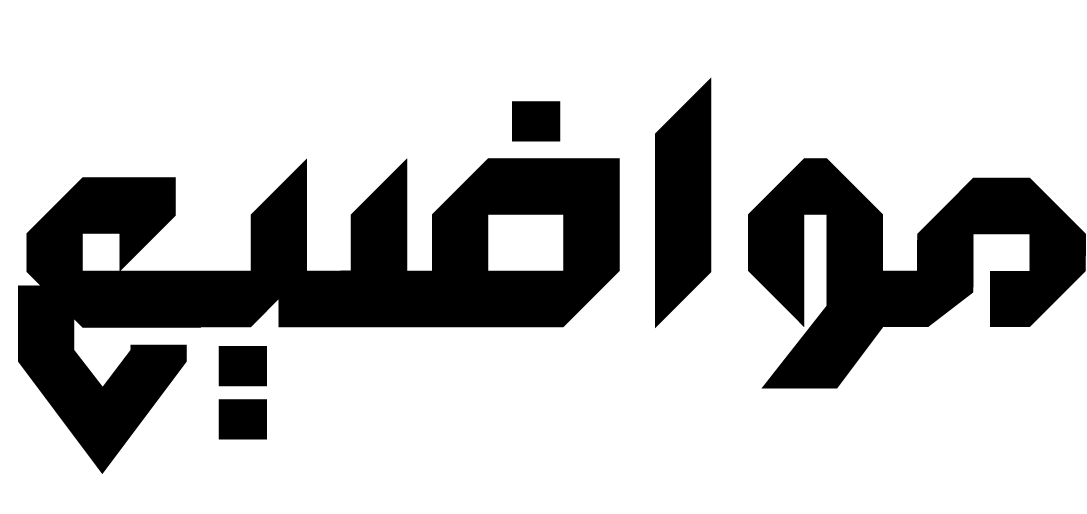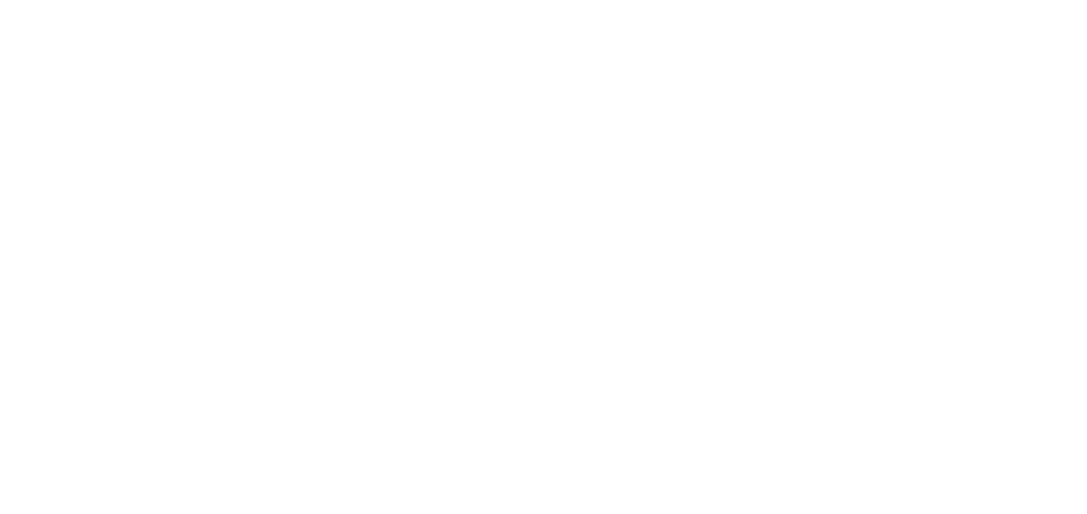أيّ المَرّتين أنتَ: قلباً وقالباً، عملاً ودعوة؟!
في عالمٍ تتقاطع فيه المواقف وتتباين فيه القناعات، يُصبح من الضروري الوقوف أمام المرآة الداخلية للنفس، ليس لمجرد التأمل، بل لاختبار صدق التماهي بين الظاهر والباطن، بين ما يُقال وما يُفعل، بين ما نُجاهر به في العلن، وما نُخفيه في أعماقنا. حين نُسأل “أيّ المرّتين أنت؟!”، فإن السؤال لا يطرح وجهاً واحداً للمقارنة، بل يضعنا أمام مواجهة مصيرية مع الذات، يطلب منا أن نُحاكم أنفسنا لا بميزان المظهر فقط، وإنما بميزان القصد، والنية، والسلوك، والرسالة.
الوجهان: إزدواجية السلوك أم تنوع التفاعل؟
المرّتان هنا ليستا مجرد حالتين متناقضتين، بل تمثلان جانبين من الحضور الإنساني في الحياة: الأول قد يكون الصدق التام بين الداخل والخارج، والثاني قد يكون الزيف أو الانفصال بين القول والعمل. وهناك من يعيش بين المرّتين حالة انشطار داخلي، يتحدث بلغةٍ تُرضي الجماهير، ويعيش حياةً لا علاقة لها بما يدّعيه. من هنا تتجلى أزمة المعاصرة: هل الإنسان هو ما يدعو إليه؟ أم هو ما يمارسه؟ وهل يمكن الفصل بين الدعوة والعمل؟ بين القلب والقالب؟ بين القناعة والسلوك؟
القلب والقالب: وحدة أو صراع
“قلباً وقالباً” ليست عبارة إنشائية تُستعمل للتأكيد فحسب، بل تعبير يدلّ على الكمال في الاتساق بين الإيمان الداخلي والمظهر الخارجي. حين يقال عن إنسان ما إنه يؤمن بشيء “قلباً وقالباً”، فهذا يعني أن تلك الفكرة أو القضية تشكّل كيانه كله. ولكن كم من البشر اليوم يملكون هذه الدرجة من الانسجام؟ وكم منّا يرفع شعاراً معيناً في العلن بينما يعيش حياته بعيداً كل البعد عن مقتضيات ذلك الشعار؟
القالب، أي الهيئة، الشكل، الكلام، والتمثيل الظاهري، هو أول ما تراه العيون، وهو ما يُبنى عليه الحكم الأول. أما القلب، فهو مكمن الإخلاص، منبع النيّة، ومرآة الضمير. الانسجام بين هذين البُعدين يعني الصدق الحقيقي، ويعني كذلك الشجاعة، لأن كثيرين يرتدون قوالب تُخالف ما يحملونه في القلوب، إما طمعاً في قبول اجتماعي، أو خوفاً من الرفض، أو استسلاماً للواقع.
العمل والدعوة: جدلية التطبيق والنظرية
ليس كل من دعا إلى فكرة مارسها، وليس كل من مارس فضيلة دعا إليها. لكن النموذج الأسمى في المجتمعات الناهضة، والمجتمعات العادلة، هو ذاك الذي يتجلى فيه التوحّد بين الدعوة والعمل، بين النظرية والتطبيق. كثيرون يدّعون الإصلاح، ويدّعون الحرص على القيم، ولكنهم في واقعهم يسلكون سلوكاً يُفقد تلك القيم معناها، ويجعل من الدعوة قشرة جوفاء لا تأثير لها.
الدعوة – سواء أكانت دعوة دينية، أو فكرية، أو أخلاقية – لا تكتسب مشروعيتها إلا حين تتجسد في سلوك صاحبها. فكم من المصلحين ظنوا أن الخطاب وحده يكفي، فإذا بالجماهير ترفضهم لأن سلوكهم اليومي يتعارض مع ما يدعون إليه. وكم من الأتقياء وُصفوا بالصمت، لأنهم لم يكونوا يرفعون شعاراً، ولكن سلوكهم اليومي كان تجسيداً لقيمٍ ومبادئ تنبض بالحياة.
في ميزان القيم الإنسانية، العمل أولى من القول، والمثال الحي أكثر إقناعاً من النظرية. فإذا أراد الإنسان أن يكون قلباً وقالباً، عملاً ودعوة، فعليه أن يُطابق فعله قوله، وأن يتطهر من التناقض الذي يُفرغ النوايا من معناها.
الأزمة المعاصرة: انفصال السلوك عن القيم
نعيش في زمنٍ تكثر فيه الخطابات وتقل فيه النماذج. الكل يتحدث عن العدل، ولكن الظلم ينتشر. الكل يدعو إلى التواضع، ولكن الغرور ينهش القلوب. الكل يُمجّد الصدق، ولكن الكذب يُزين الحديث. هذا الانفصال بين القيم المعلنة والسلوكيات اليومية أدّى إلى ما يُعرف بـ”أزمة المصداقية”، وهي أزمة ليست فقط فردية، بل بنيوية تمس المجتمعات بكاملها.
حين يُدرّس أستاذٌ في الجامعة الأخلاق المهنية، ثم يُطلب منه رشوة لتمرير ورقة، فهو يعيش ازدواجية بين دعوته الأكاديمية وسلوكه العملي. حين يتحدث زعيم عن الوطنية ثم يُحول أموال الدولة إلى حسابه الشخصي، فهو يشوه معنى الدعوة ويقضي على قيمها. هذا النمط من التناقض لا يولّد فقط الاستهجان، بل يُنتج أجيالاً فاقدة للثقة، حائرة بين القيم الجميلة التي تُقال، والواقع المظلم الذي يُعاش.
منسوب التماهي: كيف يُقاس؟
الإنسان ليس دائماً وحدة متجانسة، فهناك لحظات ضعف، وهناك ضغوط تُجبره على اتخاذ مواقف دفاعية. ولكن الفرق الجوهري يكمن في المسافة بين ما يعلنه الإنسان وما يفعله. حين تكون هذه المسافة قصيرة، يكون التماهي عالياً، ويُصبح الإنسان مرآة لقيمه. أما إذا اتسعت المسافة بين القناعة والسلوك، فإننا أمام حالة من النفاق العملي، حتى لو لم تكن مقصودة.
قياس هذه المسافة لا يحتاج إلى أجهزة علمية، بل إلى مراقبة ذاتية دائمة، ومحاسبة مستمرة. هل ما أدعو إليه في عملي أو في أسرتي أُمارسه فعلاً؟ هل أنصح الناس بتقوى الله ثم أخون الأمانة؟ هل أتكلم عن المساواة ثم أحتقر من هو دوني في المنصب أو المال أو العِرق؟ هنا يُصبح السؤال مصيرياً: أيّ المَرّتين أنا؟
النموذج الرسالي: القدوة الصامتة
في سياق الحضارات، كانت النهضات الكبرى تُبنى على أكتاف أولئك الذين عاشوا دعواتهم، ولم يكتفوا بترويجها. في التاريخ الإسلامي مثلاً، نرى النبي محمد ﷺ وهو يعيش الإسلام قولاً وفعلاً، سلوكاً وتعاملاً، في البيت وفي السوق، في المعركة وفي السلم. لم يكن النبي خطيباً فقط، بل كان قدوة عملية. كذلك هو حال المهاتما غاندي، الذي جسّد مبادئ اللاعنف في كل سلوك، حتى في وجه الاحتلال. هذه الشخصيات لم تكن تحتاج إلى تكرار شعاراتها، لأن سيرتها كانت أبلغ من كل خطاب.
هذا ما تحتاجه المجتمعات اليوم: ليس المزيد من الكتب، أو اللافتات، أو الخطب، بل نماذج حية تُجسد القيم في الميدان. ليس المقصود بذلك أن يُصبح الجميع ملائكة، بل أن يسعى كل فرد إلى أن يُقلّص الفجوة بين ما يدعو إليه وما يعيشه فعلياً.
الانفصال خطر على الذات والمجتمع
العيش بين مرّتين – أي بين صورتين متناقضتين – لا يُرهق الضمير فحسب، بل يُؤسس لحياة مزدوجة، فيها كثير من القلق الداخلي والتوتر النفسي. الفرد الذي يظهر للناس بصورة معينة، ويعيش في السر على نقيضها، يُعاني من اغتراب ذاتي قاتل. كذلك المجتمع الذي يُمجّد القيم في الإعلام ويخرقها في الواقع، يُصاب بتصدّع أخلاقي عميق.
هذا الانفصال يُنتج بيئة اجتماعية يهيمن عليها الشك والريبة، حيث لا يُصدّق الناس بعضهم بعضاً، وحيث تصبح النوايا دائماً موضع اتهام. في مثل هذا السياق، تفقد القيم قدرتها على التأثير، ويغدو الانتماء فكرة فارغة من المعنى.
نحو توحيد الذات: مشروع داخلي دائم
التحول إلى حالة “قلباً وقالباً، عملاً ودعوة” ليس حدثاً آنياً، بل مسارٌ طويل يتطلب شجاعة وصدقاً واستمرارية. يبدأ ذلك بمراجعة النفس، والتصالح مع النوايا، وإعادة النظر في السلوكيات اليومية. يتطلب الأمر أن يسأل الإنسان نفسه في كل موقف: هل أنا صادق في هذه الكلمة؟ هل يعكس مظهري قيمي الحقيقية؟ هل أسلوبي في الحديث نابع من احترام أم مجرد تصنّع؟
وحين يتخذ الإنسان هذا النهج الدائم من المراجعة، يبدأ تدريجياً في رأب الفجوة بين القول والفعل، ويُعيد بناء ذاته من الداخل، بعيداً عن الأضواء، لكن بثقة راسخة نابعة من الانسجام الداخلي.
جدول: مقارنة بين الإنسان المنسجم والإنسان المنفصل
| الجانب | الإنسان المنسجم (قلباً وقالباً) | الإنسان المنفصل (ازدواجية) |
|---|---|---|
| القول | يتحدث بما يؤمن به فعلاً | يتحدث بما يُرضي الآخرين أو يُخفي قناعاته |
| الفعل | يُمارس ما يدعو إليه | يُخالف أفعاله أقواله |
| الأثر في الآخرين | مصدر إلهام وثقة | مصدر شك وريبة |
| الحالة النفسية | هدوء داخلي واتساق | قلق داخلي وتوتر |
| المصداقية | عالية وتُبنى بمرور الزمن | ضعيفة وتنهار بسرعة |
| النمو الذاتي | ثابت ومستمر | متعثر أو مشوّش |
الخلاصة
السؤال “أيّ المَرّتين أنت؟!” لا يطرحه الآخرون علينا فقط، بل يجب أن نطرحه على أنفسنا كل يوم. ليس الهدف أن ندّعي الكمال، بل أن نعمل على تقليص المسافة بين ما نؤمن به وما نُمارسه. فقط حين نكون “قلباً وقالباً، عملاً ودعوة”، نُصبح جديرين بأن نُحدث أثراً حقيقياً في محيطنا، وأن نُسهم في بناء مجتمع تتجلى فيه القيم في السلوك، لا في الشعارات. فالصدق مع الذات هو أول الطريق نحو الصدق مع العالم.
المصادر:
-
عبد الرحمن بدوي، الإنسان والوجود، دار النهضة العربية، بيروت، 1973.
-
علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، دار الشروق، القاهرة، 2001.